
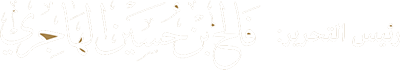

استعرضنا في المقال السابق جوانب من الأنساق الثقافية في مجموعة «عناقيد البشر» القصصية للأديب القاص القطري جمال فايز، وجوانب من القصص التي تضمنتها المجموعة، واليوم نواصل التقليب في صفحاتها، لأجل البحث عن هذه الأنساق بين ثنايا كلماتها.
يتجاوز فايز في قصة «لوطني أغني» الوطن الأصغر القُطري إلى الوطن الأكبر الأممي أو القومي، فبطل القصة يعيش في مدينة غزة، ويقوم بإصلاح قاربه، ويصف معاناته، فها هو منزله متهدم، وغرفته وسط أطلال غرفة شقيقه، ولا تزال مروحيات المحتل «تنفث دخانًا كثيفًا ملتويًا أسود، يُسمم رئة وطني»، فتحرم قذيفة ابنة شقيقه من «المشي على رجليها»، وتفقده قذيفة أخرى زوجته، وثالثة يستشهد بها أخوه وزوجة أخيه، والتي لم يتبق منها «إلا رأسها وذراعها الأيمن»، وسط ذلك يظل الأمل في «حياة» كريمة حرة على تراب الوطن»، فيخرج مقاتلا المروحية ببندقيته، إلا أن قائدها يُباغته «بإطلاقه رصاصًا كثيرًا، يستقر بعضه في جسده» فيثور بركان دمه، وينساب على جسده، كحبات الندى؛ ليروي تراب الوطن، وينطق الشهادتين مبتسمًا.

يواصل القاص في قصة «ترابي على صدري» وصف معاناة أهل غزة من الاحتلال، فبطل قصته تودعه أمه قائلة: «لا تعد إلينا حيًا»، بينما يتواصل القصف من المقاتلات والطائرات «الأباتشي»، وإذا بصديقه ينزف دمًا من قدمه اليُمنى، ويتمنى أن يلقي نظرة أخيرة على بيته، ويفزعه أن بيته «أصبح حطامًا»، وضم التراب أنامل أخته، وقد التف حول صدرها ذراع أمه. وفي وسط كل ذلك يجد المساومة على الوطن «سلمونا مقاومتكم وأرضكم؛ ندعكم تغادرون غزة بسلام».
ينتقل فايز في قصة «البوعزيزي» إلى وصف معاناة أخرى في جزء آخر من وطنه الأكبر، الوطن العربي، فيقدم سردًا لمجريات وقائع وأحداث ما حدث مع طارق محمد البوعزيزي، الذي أضرم النار في نفسه يوم 17 ديسمبر 2010، واستشهد متأثرًا بجراحه، فكان الشرارة التي فجرت الثورة التونسية؛ بل وكل ثورات ما اصطلح على تسميته «الربيع العربي»، ولهذا أقيم له تمثال لتخليد ذكراه في العاصمة الفرنسية باريس. ويجعلنا نتعايش مع بطل القصة معاناته، ومضايقة الشرطية له، وعجزه عن دفع ما يحيق به من الظلم، فهو «لم يرتكب جريمة». وفي اليوم التالي بعدما حُرم من مورد رزقه في سوق الفاكهة، يُشعل النار في جسده، أمام مبنى البلدية، وبعد ثمانية عشر يومًا أمضاها في المشفى لم يبق منه إلا اسمه يُردد.
وفي قصة «الأحمر على الأبيض يتمدد» يقدم في وصف أدبي بليغ، وكلمات موجزة، وصفًا لحمامة بيضاء، لعلها حمامة السلام على الكرة الأرضية، تنزف، وتنشغل بإطعام صغارها، وتدثرهم بجناحيها إلى أن غفا الصغار، وسكنت روحها. نتيجة إصابتها بطلق ناري من الإنسان، الذي لم يعد يملأ جوفه شيئا، فيصطاد للرغبة أو الترفيه أو «لتأكيد سيادته على الأرض» وهو لا يبالي، «ما الألم الذي يُسكنه في الآخر».
أما قصة «الباحث عن شيء آخر»، فإن أحداثها تدور في «براغ»، عاصمة جمهورية التشيك، ومع ذلك يُزيلها بهامش يقول فيه: «إن موضوع القصة لا علاقة له بالمكان»، ولا ندري سبب ذلك، فالقصة عمل أدبي ينسجه خيال الكاتب، وتدور أحداثه أحيانًا في أماكن واقعية، يصفها بدقة، ويضع لها تصورًا في كتاباته وفي ذهنيته، فالقصة القصيرة خلاصة تجربة الكاتب الحياتية والفنية، فهي تصور الحياة في لقطة، وتختصر الكون في لحظة، وتحمل التجربة الإنسانية، والممارسة الإبداعية. وبالتالي لم يكن القارئ بحاجة لهذا التبرير، اللهم إلا إذا كان القاص يرغب في التقية من أمر ما. فالقصة عبارة عن مشهد خاطف سريع، إذ يلمس أحد المارة في بطل القصة العروبة، فيحاول استجداءه شيئًا ليشتري به ما يقتات به، ورغم رفضه تقديم المساعدة، يسأله لماذا تترك وطنك وتأتي إلى هنا تستجدي الحياة، فيكون الجواب بحثًا عن «الحرية».
يقتحم القاص في قصته الأخيرة، المعنونة «كائنات بشرية»، دنيا العولمة، وتأثيرها على الإنسان العربي، وما بات ينتابه من صراع داخلي يُمزقه، فجميع الجالسين في المطعم مشغولون بأجهزتهم الخلوية، وباتوا في تمزق اجتماعي، فوالد ووالدة الطفلة مشغولان عنها بالسناب شات، وكل منهما له عالمه الافتراضي، الذي يعيش فيه بعيدًا عن مشاعر وأحاسيس الواقع، والجميع مشغولون بهواتفهم، منفصلين عن الواقع الذي يعيشونه، فأحدهما رغم مرور عشرة أيام على خطوبته؛ إلا أنه غير قادر على الحديث مع خطيبته، لانشغالها في الحديث مع صديقاتها، ولانشغاله بقراءة رسائله الإلكترونية، فكانت النتيجة أن قطعت أواصر الرحمة، وخلعت خاتم الخطبة، وغادرت المكان. فهل بات العالم الافتراضي أهم من الحياة اليومية المعاشة؟ ولماذا يحظى بالاهتمام والوقت على حساب التواصل الإنساني؟ وهل أصبح الناس بلا أحاسيس، وباتوا «كائنات بشرية»؟!

